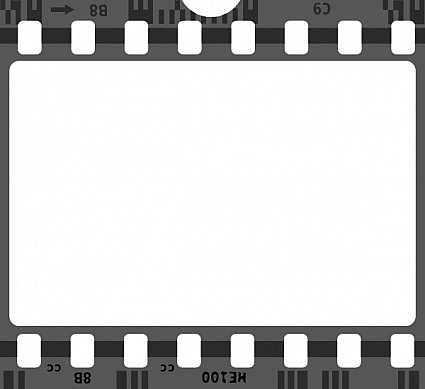بدايةً، سوف أتخيّر استخدام تعبير (المثليّة الجنسيّة)، الترجمة الأدق لـ (Homosexualité)، والأكثر اقتراباً من طبيعة العلاقات التي تُحدّدها، وتُشير إليها. وسوف أدعُ جانباً (الشذوذ الجنسي)، نعتاً شائعاً يُستخدم للإشارة إلى (انحرافاتٍ)، و(ممارساتٍ) لا علاقة لها بـ (المثليّة) التي بدأت تخترق مجتمعاتنا العربية بحذرٍ، وسريّة، تُرافقها كلّ الأفكار المُسبقة، والاتهامات المُشوّهة لرغباتٍ عرفها الإنسان منذ قديم الزمان، تتحدّد تأثيراتها في أطرٍ ضيقة، ولا تهدّد المجتمع بأيّ حالٍ من الأحوال، فهي سلوكيّات حميمة، تعتبر جزءاً من الحياة الخاصّة لأشخاصٍ ناضجين، تخيّروا بمحض إرادتهم نمطاً من النشاط الجنسي (المُختلف) عن المعهود، والمُتعارف عليه، ولا نمتلك الحق بفرض ما نعتقد بأنّه (عادي)، و(طبيعي)، وإخضاع الأقليّة لمفاهيم الأكثرية.
وترتبط (المثليّة الجنسية) بما يمكن تسميتها بـ (الحساسيّة المثليّة)، وهي بمثابة طاقة إبداعية تعكس وعيّاً مختلفاً، ومشاعر حادّة لبعض تعقيدات الأحاسيس الإنسانية المُتولدّة عن الاضطهاد، ورؤية عن عالمٍ يتشكّل، ويتحدّد عن طريق حقيقة (مثليّته الجنسية) الخاصّة به، ويتنوّع هذا الإدراك مع الزمان، والمكان بمُقتضى الظروف التاريخية التي نتواجد فيها.
ويفرز المجتمع الحاليّ الأشخاص وُفق (بطاقاتٍ) تسمح له بوضعهم في نوعياتٍ، وصفاتٍ، كحال: (طبيعي)، و(عادي)، بينما يعتبر (المثلية الجنسيّة) تصرفاتٍ (شاذّة) و(مرَضيّة).
ولكن، في خارج إطار هذه الثنائيّات، هناك أفكارٌ عن العالم، وكيفية التعايش معه، وبالنسبة للمثليّين، فإنّ (الحساسية المثليّة) هي إحدى هذه الإجابات، وهي علاقةٌ بين نشاطاتٍ، حالاتٍ، أشخاصٍ و(المثليّة الجنسية) نفسها.وبشكلٍ عام، يَعتبرُ المجتمع بأن الحبّ بين رجلين، أو امرأتين، سلوكاً شائناً، يتموقع خارج النظام الاجتماعيّ، العادي، والسوي، باختصار، (خطأً أخلاقياً).
وانطلاقاً من رفض السلوكيّات، والطبائع المُتأسّسة، والمُتوارثة، يرفض (المثليّون) “رجولةً” ترتبط عادةً بالعدوانية، وترفض (المثليّات) “أنوثةً” تقترن غالباً بالخضوع، والطاعة لرغبات الرجل، وضرورة إغوائه، وهذا يعني، بأن (المثليين) مسالمون، وليسوا ضعفاء، كما هو شائعٌ عنهم.
وقد جاء في الرسالة المُشتركة للسينمائيّتين (ماريّا كلوناريس)، و(كاتارينا ثوماداكي)- من أصلٍ يونانيّ، تعيشان في باريس- إلى (كلودي كاترين لاندي)، رداً على طلبها بالمُساهمة بتحرير العدد الخاصّ عن (السينما المثليّة) في مجلة “CinémAction” الفرنسية :
تقول (ماريا، وكاتارينا): “من السهل تصنيف الرغبات، هذا الوضع يناسب بشكلٍ خاصّ أولئك الذين يديرونها، ويتحكمون بها، ولكن، ما هو أصعب، إمكانية احترام، وقبول اختلافاتنا الجنسيّة، وتلك الخاصّة بالآخرين، وكذلك، القدرة على الإصغاء إلى الآخر، بدون الاعتقاد بمعرفتنا له مُسبقاً، لأنه ينتمي إلى هذه المجموعة، أو تلك، وبدون احتقاره، فيما لو أنه تخير مكاناً آخر غير مكاننا، إنّ الحبّ المُعاش متباينٌ، ومتدرّجٌ بشكلٍ لانهائيّ”.
تصفيات النازية للمثليين
يتخذّ (المثليّون) اليوم (المثلث الزهري) شعاراً لهم، ولكنّ معظمهم، والكثير من أفراد المجتمع، لا يعرفون جيداً تاريخه، ومعناه، فقد كان الإشارة التي ميّزتهم في معسكرات التصفيات النازية، حيث تمّ إيقاف آلاف الرجال بسبب (مثليّتهم)، وفي الحقيقة، أصبح هذا الأمر معروفاً، ولكن ما هو أقلّ معرفةً، بأن العديد من الناجين كانوا موضوعاً للاضطهاد في ألمانيا ما بعد النازية، ليس كسجناء سياسيين، ولكن، كمجرمين يخضعون لـ (قانون اللواط) الذي بقيّ في الكتب حتى عام 1969.وخلال سنوات الخمسينيّات، والستينيّات، كان الهروب انتحاراً، الزواج، أو التقوقع، بمثابة ممارساتٍ مشتركة بين (المثليين). وحتى اليوم، ما يزال العزل مستمراً، وعدم الاعتراف بضحاياهم، ليس في ألمانيا فحسب، ولكن، في بلدانٍ أوروبية أخرى.
الفيلم التسجيلي (الفقرة 175) من إنتاج (الولايات المتحدة)/1999 لمخرجيّه (روب إيبستايّن)، و(جيفري فرايّدمان)، يُظهر بأنه خلال الفترة (1933-1945) اعتقل النظام النازيّ حوالي (100.000) رجل من جنسياتٍ، ودياناتٍ مختلفة، بسبب مثليتهم الجنسية فقط، وانتهى(10.000) منهم في معسكرات التصفية.
يكشف الفيلم عن صفحة مجهولة من تاريخ الرايخ الثالث، اضطهاد (المثليين)، عبر شهاداتٍ بالغة الحساسية لخمسةٍ من الناجين سيقوا إلى معسكرات التصفية تطبيقاً للفقرة 175 من القانون الجزائيّ الألماني لعام 1871، والذي أُلغيّ في عام 1994 .
يتخلل الفيلم وثائق أرشيفية نادرة، وحركة كاميرا (ترافلينيغ) فوق خطوط السكك الحديدية، تُذكّر بتلك الرحلة المأسوية، إنّه فيلمٌ تقشعر له الأبدان، يتعقب أثر التاريخ المُؤسف لـ(المُثلث الزهري) الشهير .
وتكشف اللقاءات المُنجزة بحذرٍ، عن الذكريات الجميلة، والحزينة لشهودٍ جمعتهم أقداراً محطمة، وكبتوا آلامهم لفترةٍ طويلة.
محاكمة سيرجي بارادجانوف
وبقراءة العدد الخاصّ من مجلة CinémAction /1983 عن “السينما المثليّة”، لم تكن المفاجأة بالنسبة لي اكتشاف “مثليّة” هذا المخرج العظيم، ولكن، الثمن الباهظ الذي دفعه في ظلّ النظام الشيوعيّ، الذي كنت أعتقد بأنه لا يُعير اهتمامًا لعلاقة الفردّ بجسده، والتوجهات الغريزية، أو المُكتسبة، لرغباته الجنسية.
في الوثيقة القضائية الصادرة بتاريخ “30 ديسمبر 1977″، حُكم على سيرجي بارادجانوف في “25/4/1974″ من محكمة القضايا الجنائية لمدينة “كيّيف” بالسجن لمدة خمس سنوات، وقضى عقوبته خلال الفترة من “17 ديسمبر 1973″ وحتى “30 ديسمبر 1977″، وأُخليّ سراحه قبل قضاء المدّة الكاملة “11 شهراً و17 يومًا”، وجاء في حيثيّات الحكم ما يلي:
وُلد سيرجي بارادجانوف بتاريخ “9 يناير عام 1924″ في مدينة تيفليس، أرمينيّ الأصل، غير منتسبٍ لأيّ حزبٍ سياسيّ، حصل على تعليمٍ عالٍ، مُطلّق، يسكن في “كيّيف”، يعمل كمخرجٍ في استوديو للأفلام الفنية، حُكم عليه مُسبقاً لارتكابه جرائم تتعلّق بالفقرة الأولى من المادتين (122)، و(211) لقانون الاتحاد السوفييتي.
مارس المُتهم بارادجانوف علاقات مثليّة مع عددٍ من الأشخاص، ومنهم المتهميّن كوندراتيّيف وبيسكولوفوي، وحصل ذلك في بيته الكائن بشارع شيفتيّينكو رقم 43. وقد مُورست تلك الأفعال بالتراضي، أو بالتحريض، والوعود، وأحيانًا بالعنف، وأكثر من ذلك، أظهر المتهم صوراً إباحية لأشخاصٍ كانوا يزورونه في بيته.
مارس المُتهميّن كوندراتيّيف، وبيسكولوفوي خلال العاميّن 72/73 علاقات مثلية مع المُتهم بارادجانوف في بيته، وكان كوندراتيّيف يُظهر صوراً إباحية لأصدقائه.
عمل بارادجانوف، وكوندراتيّيف معاً في تصوير أحد الأفلام، الأول كمخرج، والثاني كمساعدٍ له. في شهر ديسمبر من عام 1972، دعا بارادجانوف المتهم كوندراتيّيف إلى بيته ليتناقشا في أمور العمل، وأقنعه بممارسة علاقاتٍ مثلية معه، مُتخذاً دور الشريك الفاعل.
في بداية عام 1973، وبمناسبة الزيارة الثانية للمتهم بارادجانوف، اقتنع كوندراتيّيف مرةً جديدةً بممارسة أفعالٍ مثلية، باتخاذ نفس الدور السابق. في نهاية شهر أغسطس 1973، تعرّف المتهم بارادجانوف على المتهم بيسكولوفوي في كلية الهندسة المدنية، ودعاه إلى بيته، بعد أن وعده بتصويره، هناك، أقنعه بممارسة علاقاتٍ مثلية معه، متخذاً دور الفاعل، ومن ثمّ اتفقا على مواعيد مستقبلية.
في نهاية شهر أكتوبر 1973، جاء بيسكولوفوي مرةً أخرى إلى كيّيف لإنهاء بعض الأعمال، ودُعيّ لزيارة بارادجانوف في منزله، وطلب منه أن يمارسا من جديدٍ أفعالاً مثلية، حيث كان بارادجانوف فاعلاً، وبيسكولوفوي مفعولاً به.
في مساء (6 نوفمبر من عام 1973)، كان الشاهد فوروبيّيف ثملاً عندما حضر إلى بيت بارادجانوف، ونام فوق السرير، وعلى الأرجح، كان قد خلع ملابسه، فاغتصبه المتهم بارادجانوف بممارسة فعلٍ مثليٍّ معه.
في مساء 13 ديسمبر من عام 1973، حضر ديسياتينك – وهو تلميذٌ في مدرسة السيرك- إلى بيت بارادجانوف، الذي وعده بتصويره، ومن ثمّ أقنعه بممارسة أفعالٍ مثليّة معه.
في مراتٍ عديدة، خلال الفترة (1968-1973)، أظهر المتهم بارداجانوف للعديد من الأشخاص الذين كانوا يزورونه في بيته رسومات إباحية مُقتطعة من مجلاتٍ أجنبية، أو تظهر على خلفية أوراق اللعب، أو صوراً فوتوغرافية.
وبتطبيق المادتين (323)، و(324) للاتحاد السوفييتي، فإنّ الهيئة القضائية للقضايا الإجرامية لمحكمة مدينة (كيّيف)، تُدين (بارادجانوف) للجرائم المُشار إليها:
– السجن عاماً، تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (122).
– السجن خمسة أعوام، تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (122).
– السجن عاماً، تطبيقاً للمادة (211).
وبتطبيق المادة (42) للاتحاد السوفييتي، يُعتبر الحكم النهائيّ بمثابة العقوبة الأكثر صرامةً، حيث حُكم على (بارادجانوف) بالسجن لمدة خمس سنواتٍ في أحد معسكرات الأشغال الشاقة.
المثليّة الجنسيّة في السينما
ورغم أنّ “المثلية الجنسيّة” كانت ظاهرةً خفيّةً، ومُستترة، إلاّ أنها ليست جانبًا جديدًا في السينما، فقد قدّم الإنتاج الهوليووديّ من الثلاثينيّات، وحتى الخمسينيّات الكثير من الأمثلة.
كما اجتازت السينما في السبعينيّات عتبةً جديدة نحو العلانيّة، وبينما سمحت الستينيّات للمخرجين بإظهار أثداء المرأة عاريةً على الشاشة، كشفت السينما في السبعينيّات عن الحب الجسديّ بكلّ أشكاله.
واليوم، لا تخلو مئات المهرجانات السينمائية من فيلمٍ يتطرّق للمثلية الجنسية، وبعضها في: باريس، هامبورغ، دوبلين، لندن، تورينو، بولونا،….تخصصّ تماماً بهذا الموضوع.
وخلال الفترة الأخيرة، تسنّى لي مشاهدة (172) فيلمًا روائيًا طويلاً، تطرّق (34) منها – من قريبٍ، أو بعيدٍ- لـ”المثليّة الجنسية”، الرجالية، أو النسائية، بحيث كانت موضوعًا أساسيّاً لها، أو أظهرت شخصياتٍ فاعلة في تطوّر أحداثها، ومقتضيّات السرد الفيلميّ.
ويُشير ذلك -بشكلٍ ما- بأن هذا الموضوع يُشكّل (20)% تقريبًا من مجموع عيّنات الأفلام التي شاهدتها (عشوائيّاً). ومن المُفيد هنا، التعرّف قليلاً على طبيعة المُعالجة السينمائية للمثليّة الجنسية، وفهم الاقترابات المُقترحة لشخصياتٍ وجدت في حياتها (اختلافاً)، فجسّدته سلوكًا، وممارسةً، وحطمت محرّماتٍ اجتماعية، أخلاقية، دينية، ونفسية،….
المثلية الجنسيّة في السينما الأوروبيّة
في The Rope/الحبل (انكلترة/1948)، الفيلم المُلوّن الأول لـ”هيتشكوك”، وأكثر أفلامه مسرحةً، حيث أراد إنجازه في لقطةٍ واحدة متصلة، ولكنّ حتمية المدة الزمنية لبكرة الشريط في علبته، أجبرته بأن يكون هناك (11) لقطةً لا مهرب منها، أُنجزت بإخراجٍ لا يستطيع المُتفرج العادي اكتشاف أماكن القطع فيها أبداً.
في الفيلم، براندون، وفيليب طالبان (مثليّان) يرتكبا معًا جريمةً مجانية، إنهما يخنقا بدمٍ باردٍ رفيقهما دافيد، ليحققا بشكلٍ عمليٍّ نظرية أستاذهما القديم روبيرت كاديل، بمُقتضاها، يجب التخلّص من أيّ شخصٍ لا ينتظر المجتمع منه شيئًا، يُخبّئا الجثّة في صندوقٍ، يُنظما حفل عشاءٍ، ويدعوا أستاذهما، والمقرّبين من الضحيّة….
ليس من السهل هنا التعرّف على (السلوك المثليّ) للشخصيّتين الرئيسيتين، ولست ميالاً للربط بين جريمتهما المُشتركة، و(مثليّتهما)، ولكن، هل يمكن استيحاء قراءة أخرى للفيلم انطلاقًا من تصفية الصديق المُشترك، والذي لم يكن اختيار اسمه دافيد مجانيّاً .
يقدم هيتشكوك شخصيةً مثليةً أخرى، لن تتهاون في ارتكاب جريمة قتلٍ، والتحريض على أُخرى مُماثلة.
كان ذلك في فيلمه Strangers on a Train/غريب في القطار”(إنكلترة/1951)، حيث يلتقي برونو صدفةً بلاعب التنس الشهير (غايّ)، فيعرض عليه اغتيال زوجته التي ترفض الطلاق منه، مقابل أن يتخلّص غايّ من والد هذا المجهول، وإذّ يبدو بأنها مقايضةً غريبة، يمتعض غاي منها، إلاّ أنّ برونو يذهب بأفكاره، ومخططاته بعيداً، ….
لم يكن هيتشكوك رحيماً مع برونو الذي يريد غواية غايّ، ولكنه أظهر (مثليّته) بذكاءٍ، وحذق، وعن طريق إشاراتٍ متتالية : اهتمامه المُبالغ بمظهره، طريقة كلامه، سلوكه الاجتماعيّ المُنفتح كثيراً، شفافيّته، حبّه للظهور، وجذب الانتباه،…
وهو متعلّقٌ بأمّه، يسخر كثيراً من أبيه، ويكرهه إلى حدّ الرغبة بقتله، مهووسٌ بالفكرة بشكلٍ مرضيٍّ، تدفعه لقتل زوجة غايّ لاعب التنس، وإصراره بأن يُقدم الأخير على قتل أبيه، كما يبدو له اتفاقاً عند لقائهما الأول في القطار.
ولكن، لا شيئ يربط بين مثليّة برونو، ونزعاته القاتلة، إنها فقط، كراهية الأبّ الذي يرفض سلوك ابنه “ربما يعرف بأنه مثلي”، أو هي قراءةٌ هيتشكوكيّة لـ”عقدة أوديب” العاجز عن اللقاء بأي امرأةٍ غير أمّه، وحتى عن قتل أبيه.
وبالانتقال زمنيّاً من بداية الخمسينيّات إلى نهاية القرن العشرين، تتغيّر معها نظرة المجتمع إلى (المثليّة الجنسية) بنسبٍ متفاوتة.
في Room to rent/غرفة للإيجار”(إنكلترة- فرنسا/2001) يقدم المخرج المصريّ خالد الحجر فيلماً يلخص من خلاله الحياة التي عاشها علي في لندن، ومحاولاته التأقلم، والعيش في بلدٍ غريب، سعياً وراء كتابة سيناريو للولوج به إلى عالم السينما.
وبفعل إصراره، وعزيمته، ومساعدة المُقرّبين منه، ينجح في الوصول إلى طموحه بعد امتحاناتٍ حياتية صعبة، البعض منها حقيقيّ، والأخرى مُتخيّلة. ومن بين الشخصيات التي تصادفه في هجرته، مصورٌ فوتوغرافيّ مثليّ يُعجب بالشاب الجميل، ويرغب بمساعدته، يمنحه عملاً، وسكناً مؤقتاً، والوقوف أمام كاميرته عاريًا. خلال الفترة التي يقضيها علي عنده، يتعرّف يوماً بعد يوم على عالم المثليّة الجنسية، بدون الانخراط فيها تماماً.
يحتفي المصور الفوتوغرافيّ بالجسد، كما حال كلّ المثليين، ولكنه لا يطمح مقايضةً مع علي الملتزم بتعاليم دينه، وعادات، وتقاليد المجتمع الذي جاء منه. وكما حال “الحياة الكبيرة” للفرنسيّ فيليب داجو، يصبح المثليّ هنا واحداً من الشخصيات الإيجابية التي ساهمت بشكلٍ ما في دفع الشخصية الرئيسية نحو الأمام .
في Cercle intime (The Monkey’s Mask)/ حلقة حميمة” (إيرلندة/2000) لمخرجته (سامانتا لانغ)، تتضح المشاعر العدائية نحو الشرطية السابقة (جيل) من طرف رئيسها السابق في العمل، وذلك فقط، بسبب مثليّتها الجنسية، وهي اليوم تعمل لحسابها كمحققةٍ خاصّة، وتحاول حلّ لغز مقتل طالبة شابة، تلتقي بـ”ديانا”، أستاذة مادة الشعر، المتزوجة من رجلٍ يصغرها كثيراً، تتقارب المرأتان من بعضهما، حتى لحظة اكتشاف الزوج بأنه القاتل،………
في Fucking AMAL (السويد/1999) لمخرجه لوكاس موديسّون، لم تستطع ألين التعبير عن حبّها لـ”آنيّيس”، صديقتها في المدرسة، وهما مراهقتان تعيشان حياةً مملّة في”AMAL”، إحدى قرى السويد، ومع ذلك، سوف تأخذ حياتهما منحنىً جديداً، تلتقيا ذات مساء، ولكي تذهب الواحدة نحو الأخرى، عليهما بأن تحطما العادات، وتجتازا طريقاً صعباً، منثوراً بالحرية، الرغبات الجديدة، والحب بدون حدود…..
لوكاس موديسّون نفسه قدم عام 2000 فيلمه المُعنون Together/معاً”، يعود بأحداثه وشخصياته إلى ستوكهولم عام 1975، حيث اتسمت سنوات السبعينيّات بحركاتٍ نضالية، واجتماعية، تنشد الحريات الشخصية، والجماعية.
في الفيلم، تعاني إليزابيت من عنف زوجها السكير المتهوّر، تهرب مع أطفالها، وتعيش مؤقتاً مع أخيها، ومجموعته “معاً”، وفي أجواءٍ من الحرية، والانطلاق، تكتشف الشخصيات أفكارها، وتختبر أحاسيسها ورغباتها، يتباعد بعضها، وتلتقي أخرى، في محاولة البحث عن مجتمعٍ أكثر محبةً،….
يكشف المخرج عن الرغبات الإنسانية، والجنسية بشكلٍ خاصّ، في تعقيداتها، وتناقضاتها، ولا يتورّع عن تغليف تعاطفه مع الشخصيات المختلفة بنظرةٍ انتقادية حادّة للحريات المُنفلتة، وتسبّبها بتشظي العائلة، والمجتمع، ولكنه لا يقف ناصحاً، أو مرشداً اجتماعياً، ولا ينحاز لطرفٍ على حساب آخر، إنه يتركهم يكتشفون بأنفسهم أفكارهم، وممارساتهم، بهدف إيجاد صيغة أخرى للتعايش المشترك.
في O fantasma/أيتها الرغبة الدفينة”(البرتغال/2000) لمخرجه جواو بيدرو رودريغيز، تأخذ (المثليّة الجنسيّة) منحىً آخر، تختلط فيها الرغبات الجامحة، بالتعلق الهوسي بالأشياء، وتؤدي إلى الانحراف.
منذ اللقطات الأولى للفيلم، نغوص في عالم غريب بالأبيض والأسود، كلبٌ يعوي، ويخربش بأظافره باباً مغلقاً، تلتمع عينان من خلف قناعٍ بلاستيكيّ أسود، ونبدأ بالتعرّف على سيرجيّو، شابٌ يبني العالم على مقاسه، إنه يلعب ليربح، لا يكترث بأيّ شيئ، يقضي وقته في فندقه الرخيص، متعلقاً بوحدته، بالأعضاء الجنسية للرجال، برغباته المثلية الدفينة، وبمهنته كعامل نظافة في شمال ليشبونة، ولكن، في ليلةٍ ما، تجد عيناه شبح أحلامه، وتحت رحمة مجهول، تقوده رغباته النهمة، والجشعة إلى القتل، ومثل كلبٍ أجرب يهيم على وجهه، تقذفه الشوارع إلى مزبلةٍ كبيرة، ليبحث عن طعامه، ويعوي هناك.
الأوضاع ليست أحسن حالاً في بروكسيل، حيث تدور أحداث فيلم Mauvais Genres/أنماطٌ سيئة(فرنسا/2001) لمخرجه فرانسيس جيرود، وخاصةً بالنسبة لـ”متحول جنسيٍ” ينخرط في بحوثه الخاصّة ليتخلص من الظنون التي تُثقله، واكتشاف قاتلٍ لا يرحم المومسات، ويصطادهنّ الواحدة بعد الأخرى.
فيلمٌ آخرٌ يطرح تساؤلاّ تهكمياً: في صيف عام 1969 Que faisaient les femmes pendant que l’homme marchait sur la lune ?/ماذا كانت النساء تفعل عندما كان الرجل يمشي فوق سطح القمر؟” (فرنسا/بلجيكا/كندا/2000) لمخرجته كريس فاندير ستابين.
لقد عادت ساشا من مقاطعة كيبيك إلى بلجيكا في زيارةٍ قصيرة، لتعترف لأمها – التي كانت ترغب بأن تراها متزوجةً، وطبيبة – بأنها تحبّ فتاةً أخرى .
كيف يمكن إفهام العائلة بأن ابنتهم الكبرى قد تركت دراسة الطبّ، وأصبحت مصوّرة فوتوغرافية، وهي ترغب العيش في كندا مع امرأةٍ تحبها؟ هل يتوجب عليها الانتظار حتى تطأ أقدام نيّيل أرمسترونغ سطح القمر؟
لا، في الحقيقة، بعد صداماتٍ عائلية متفرّقة، تنجح ساشا بفرض اختلافها، كحال أختها القصيرة القامة، والجدّة التي تبحث بدورها عن حبٍّ ضائع، والأمّ التي فقدت منذ وقتٍ طويل الجانب العاطفيّ، والجنسي مع زوجها، وبدأت تُعوض ذلك باستنشاق الكحول، وممارسة العادة السرّية، هذا الاعتراف بالاختلاف، الاقتناع به كاملاً، أو ناقصاً، والتصالح معه، هو الذي يجمع أفراد العائلة من جديدٍ حول طاولة الطعام، في توافقيّة حقيقية، أو مُصطنعة، ولكنها مع ذلك، كانت الخطوة الأولى نحو قبول الآخر كما يحبّ أن يكون.
وبعد أن صرّحت ساشا لعائلتها عن مثليتها، فإنّ ستيفان، الناقد السينمائي السابق في مجلة (دفاتر السينما)، يذهب إلى الولايات المتحدة للبحث عن والده الذي لا يعرفه أبداً، صديقه السينمائي سباستيان يلاحق آثار الشاب في بحثه عن الجذور، La Traversée/العبور(فرنسا/2001) لمخرجه سباستيان ليفشيتز مذكراتٌ شخصية مؤفلمة لا تنقصها الحميميّة، ويمكن أن يُعيد مثليّة ستيفان لافتقاد الأبّ، وبحثه عنه في علاقاته الذكورية، وابتعاده عن المرأة لارتباطه بأمٍّ لم تعوضه سلطة الأبّ، كما يكشف الفيلم بالآن عن حالة التشظيّ المرعبة التي يعيشها المجتمع الغربيّ، حيث تحوّل الفرد إلى وحدةٍ مقتلعة الجذور، وهو في بحثٍ دائبٍ عنها، ولكنه، عندما ينجح، فإنّه لم يعدّ يمتلك القدرة على العيش وسط مجموعة من جديدٍ، وفي أجواءٍ عائلية تحفظ له توازنه النفسيّ المُفتقد، وأعرف بأن الفرد الغربيّ يرفض مُسبقاً هذا التشخيص المُبسّط، وعلى الرغم من أزماته النفسية المتواصلة، فإنّه يسعى بشكلٍ مرضيٍّ نحو فرديته، عزلته، …وتوّحشه.
في La Boîte/الملهى الليلي”(فرنسا/2001) لمخرجه كلود زيدي، مجموعةٌ من الأصدقاء يعيشون في الريف الفرنسي، ويعتقدون بأن كلّ شيئٍ ممكن، وبعد مشاجرة حاميّة في أحد الملاهي، يُمنعون من الدخول لمدة عامٍ كامل إلى كلّ الملاهي الليلية، هذا العقاب الجماعيّ سوف يجعلهم يهيمون في الشوارع لفترة (52 أسبوعاً) متتالية، إنه بمثابة كابوس لا يُحتمل، يتخيل الأصدقاء الستة طريقةً ذكية للخروج من هذا المأزق، تأسيس ملهاهم الخاصّ في كاراج والد أحدهم.
وهكذا، يتحولون إلى حارس، تقنيّ للموسيقى والصوت، نادل، مسؤول الصندوق، مدير، وحارس الأخلاق الحميدة، وسوف يقوم الأخّ “المثلي” مع راقصة شابّة، وجميلة بتحويل المكان الجديد إلى الملهى الذي يحلمون به، ولكن، من جهةٍ أخرى، يزداد قلق أصحاب الملاهي في باريس، ويُثير الخصومة.
وتتوضح المثليّة الجنسية في Absolument fabuleux/رائعٌ بشكلٍ غير معقول”(فرنسا/2001) لمخرجه غابرييل أغيّون) من خلال لقطتين تُظهرا العلاقة بين شابٍ عربيّ”يقوم بدوره جمال دبوز” وزوج المرأة الهستيرية التي تستخدم هذه العلاقة سلاحاً للتشهير بزوجها السابق، وإجباره على دفع تعويضاتٍ شهرية لها، وتُعتبر المثليّة هنا بمثابة خيانة زوجية، وحتى مصدر تهديدٍ، وابتزاز.ويشهد La Répétition/البروفة” (فرنسا/2000) لمخرجته كاترين كورسيني على الصداقة الحميمة التي تربط بين ناتالي وليزا منذ الطفولة.
تمثل ناتالي كلّ ما ترغب ليزا بأن تكونه، وتريد تحقيقه: الموهبة، والجاذبية، إنها تدخل في حياة هذه الصديقة المحسودة، تتردّد بأن تحبها، تسكنها، وربما تحطمها،… وتتحول رغبتا الامتلاك، والغيرة إلى عداءٍ مُستديم، ولا تنتصر “المثليّة الجنسية” بين المرأتين في نهاية الفيلم، لأنها لم تكن أكثر من رغبة الاستحواذ على الآخر، روحاً، وجسداً، ولهذا، تبقى ناتالي وحيدةً متعلقةً بشخصياتها التي تمثلها على خشبة المسرح، بينما تعيش ليزا مع الصديق السابق لـ”ناتالي”، ولكنها لم تنسى أبداً بأنها أحبت صديقتها حتى الرغبة الدفينة بقتلها.
في Loin/بعيداً”(فرنسا- إسبانيا/2000) لمخرجه أندريه تيشينيه اقترابٌ آخر للمثليّة. سيرج، سائق شاحنة بضائع، يسافر من أوروبا إلى أفريقيا، ويأتي بشكلٍ منتظم إلى طنجة، حيث يلتقي بعشيقته (سارة)، وصديقها سعيد، ولكنّه، هذه المرة، سوف يترك نفسه لمحاولة تهريب، ويتغيّر نمط حياته. من بين مجموعة الشخصيات المُتعددّة في الفيلم، الشاب المثليّ فرانسوا، خجولٌ، وضائعٌ تقريباً في طنجة، وقد جاء إليها لتحضير مشروع فيلمٍ يفكر به، وعلى الرغم من حبّه المُضمر للشاب المغربيّ سعيد، إلاّ أنّه لا يتخطى حواجز العادات، والتقاليد، ويحتفظ بمثليّته، ورغباته لفرصةٍ أخرى .
وفي فيلم Ceci est mon corps /هذا هو جسدي”(فرنسا/2001) لمخرجه رودولف ماركوني، ينتظر أنطوان مستقبلاً محدداً مسبقاً: “مدرسة التجارة العليا”، وقريباً، أو بعد زمن، كرسيّ الإدارة في شركة والده الثريّ، (أنطوان) شابٌّ لامع، ولكنه يعيش حالةً من الملل، وبرغبة التسلية، أو التحديّ، يقبل الدور الأول في فيلمٍ كان من المفترض أن يمثله لوكا المثليّ الذي انتحر في ظروفٍ غامضة، بعد علاقةٍ عابرة- ولأول مرةٍ في حياته- مع مخرجة الفيلم المُفترض، حتى عشيقه جويّل – الذي بدأت علاقته معه معتمدةً على الابتزاز، وتحولت فيما بعد إلى علاقة حبّ- لا يعرف دوافع انتحاره.
والدور الذي يجب أن يمثله أنطوان في الفيلم المُزمع إنجازه هو عن شخصية “مثلي”، وربما يكون تجسيداً لحياة لوكا. وبدورها، عاشت المخرجة علاقة حبٍّ مع امرأةٍ لمدة سنتين، واكتشفت فيما بعد، بأن حياتها الشخصية ليست في هذا الدرب. يكتنف علاقة أنطوان مع صديقته الكثير من الغموض، والالتباس، وقليلاً من العجز، وهو لا يستطيع أيضاً تلبية رغبة المخرجة، ويبدو بأنه يعاني من مشكلةٍ ترتبط – ربما- بمثليّته الجنسية المُضمرة.
في أجواءٍ تفتقد التوافق، والحميميّة، يتوزع أفراد العائلة الصغيرة خلافاتهم، ويعيش كلّ واحدٍ منهم أزماته متضافرةً مع تلك الخاصة بالآخرين، حيث تنتصر التمزقات العائلية، وتتفجّر المعاناة الوجودية لـ”أنطوان”.ولكن Ce vieux rêve qui bouge /هذا الحلم القديم الذي يتحرك”(فرنسا/2001) لمخرجه آلان غويرودي يقدم شخصيةً مثليةً أكثر صرامةً، وتحدياً.
تدور أحداث الفيلم في الريف الفرنسيّ، وبالتحديد، في مصنعٍ على وشك الإغلاق، لم يبقَ فيه أكثر من دزينةٍ من العمال، يأتي ميكانيكيّ شابّ لفكّ آخر آلة، تشبه “قضيباً” عملاقاً، وبينما هو غارقٌ في عمله، ينتظر الآخرون نهاية الأسبوع بالثرثرة، والتسكّع، وسرعان ما يُعبّر العامل النشيط صراحةً عن “مثليّته الجنسية” لرئيس العمال أولاً، ولا يتورّع عن إغوائه، بينما يكشف له أحد زملائه عن رغباته، بدون أن تتحقق.
هنا، يؤكد العامل الشاب على “اختلافه”، مرةً عن طريق نشاطه الملحوظ بفكّ آلةٍ جامدة، وغريبة، في وسط مصنعٍ مهجورٍ، وبعض عمالٍ خاملين ينتظرون حفل الوداع، وأقدارهم.ومرةً ثانية بـ”مثليّته الجنسية” التي لا يكشفها سلوكه، أو مظهره الشكليّ، ولكنّ، بردوده المباشرة على تساؤلات زملائه الفضولية : إنّه بلا أطفال، غير متزوج، لا يهتم بالنساء، وينجذب إلى الرجال،…..
بمثليّته، يرفض “المؤسّسة العائلية”، كما المساعدة في مهمّته، ويفضّل إنجاز عمله بمفرده.وكما يتقبّل ببساطةٍ اقتناع رئيس العمال بعدم مشاركته رغباته المثليّة، فإنه لا يمتلك جواباً محدداً، وقاطعاً لأسباب تصدّيه المرن اشتهاء زميله المُسنّ له.
يتميّز الفيلم بابتعاده تماماً عن “الأجواء الاحتفاليّة” للمثليين، وتتأكد فيه حالة التصالح مع الجسّد بدون الخوض في مطالباتٍ نضالية، بحثاً عن اعترافٍ، وحقوق، وتخلصاً من تمييزٍ يمارسه أفراد المجتمع “العاديين” نحو “المثليين”.
في La Grande Vie !/الحياة الكبيرة” (فرنسا/2001) لمخرجه فيليب داجو يغوص مارسيللو في نومٍ سريريّ، ويجلس الملاك حارسه بجانبه فوق السرير، يتدخل للدفاع عنه، كي يمنحه “ملاك الموت” وقفاً للتنفيذ، وفرصةً أخرى للحياة.
ولدعم هذه الرغبة، يلاحق ملاك الموت أثر الأسابيع الأخيرة لمارسيللو، لقد بدأ كلّ شيئٍ في باريس، عندما تدّخل ماكس المثليّ في بداية الفيلم لحماية الموسيقيّ المتشرّد مارسيللو من فظاظة أحد أصحاب المقاهي، الذي منعه من الغناء بجانب مقهاه، وطرده من الشارع، تخلصاً من موسيقاه المزعجة.
وعلى غير المتوقع، يُظهرماكس صورةً جديدةً للمثليّ، في بيته الصغير المتواضع، يتبادر إلى الأذهان بأنه سوف يحاول إغواء مارسيللو، إلاّ أنه يتصرف بشهامةٍ، وكرم، وبعد ليلةٍ هادئة في غرفتين منفصلتين، يأتي الصباح، يحمل معه كرماً جديداً، ماكس يمنح مارسيللو دراجةً نارية قديمة الطراز سوليكس، ومبلغاً من المال، ويحرّضه على السفر إلى مارسيليّا.ومنذ تلك اللحظات، ينتهي دور ماكس، وتبدأ رحلة مارسيللو الجميلة، والطريفة لاكتشاف الناس الحقيقيين في طريقه نحو الجنوب، بعيداً عن صخب مدينة باريس.
وأخيراً، فإنّ Les Rois mages/الملوك المجوس”(فرنسا/2001) لمخرجيّه ديدييّه بوردون، وبرنار كامبانا على وشك الوصول إلى إسطبلٍ في بيت لحم، حيث وُلد “عيسى” المسيح، الطفل الذي سوف يغيّر من قدر البشرية، ولكنهم يجدون أنفسهم فجأة قد امتصهم الزمان، وقذفهم في عصرنا الحالي في ثلاثة أماكن مختلفة فوق سطح الأرض، ولكنّ العناية الإلهية تقود خطواتهم، ليستعيدوا مهمتهم، بمعنى، العثور على المسيح الجديد، وهاهم في طريقهم نحو باريس، مكاناً يقودهم إلى سلسلةٍ من المواقف، والتعقيدات، حيث يتعرفون على ماشا، جو، وحيدر، هم بشكلٍ ما: مريم، جوزيف، وهيرود الأزمنة الحديثة.
وفي وسط هذه الأحداث الكوميدية للملوك الثلاثة “ميلكيور، غاسبار، بالتازار” في بحثهم عن ماشا، دليلهم الروحيّ للعثور على الابن المسيح، يلمح أحدهم من بعيدٍ فتاةً من ظهرها، فيتبعها، ظناً بأنها ماشا التي يبحث عنها، وعندما يلتقي بها في إحدى عربات المترو، تدير له ظهرها، فيكتشف – ومعه المتفرج- بأنه شابٌّ “مثلي” بصحبة صديقه، يرتدي ملابس مشابهة لما كانت ترتديه “ماشا” في مشاهد سابقة، وجهه يشبه أيضاً وجهها العذريّ، ولا يقلّ عنها لطفاً، وسماحةً، حيث يرشده إلى المحطة التي يجب أن ينزل فيها للذهاب إلى “معهد المسرح” الذي تتابع “ماشا” دروسها فيه.
لم يكن ممكناً إظهار هذه المُفارقة الكوميدية، بدون إلحاح الصورة على المظهر الأنثوي للشابّ، سلوكاً، ومظهراً، وبالطبع، ينتهي المشهد عند هذا الحدّ، بدون إقحام التعاليم الدينية، والدخول في دروسٍ أخلاقية، وتطهيرية.
ـــــــــــــــــــــــ
صلاح سرميني هوناقد سينمائي مصري مقيم في باريس؛ يُنشر بتفضل منه
نشر النص في زاوية كويريات - موقع قديتا